مما علّمتني التجربة: الطريق إلى أن تصبح المؤلف الأول
17 December 2025
نشرت بتاريخ 7 نوفمبر 2023
قطعت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي شوطًا طويلًا نحو امتلاك ذكاء آلي.. فهل الخطوة القادمة هي امتلاك وعي آلي أيضًا؟
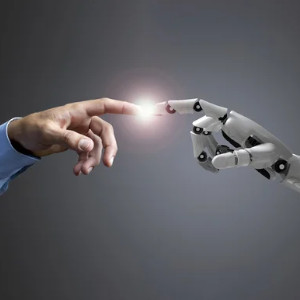
وقد تجلَّى التقدم المُحرز في رصد آثار الوعي هذه في فعاليةٍ عامة نُظِّمت مؤخرًا في مدينة نيويورك الأمريكية، وتضمنت منافسةً - أو "تعاونًا بين متخالفين" (adversarial collaboration) كما توصَف تلك الممارسة في الأوساط العلمية - بين أنصار نظريتي الوعي السائدتين في يومنا هذا: نظرية المعلومات المتكاملة (IIT)، ونظرية مساحة العمل العصبية الشاملة (GNWT). وقد وصل الخلاف إلى ذروته بحسم رهانٍ عمره 25 عامًا بيني وبين ديفيد تشالمرز، الفيلسوف المتخصص في فلسفة العقل بجامعة نيويورك.
كنتُ قد راهنتُ تشالمرز على أنَّ هذه الآثار العصبية، التي تُعرَف بين أصحاب المجال بالمُلازمات العصبية للوعي، ستكون قد اكتُشفت ووُصِّفَت بوضوح بحلول شهر يونيو عام 2023، على أن يُهدي الخاسر من فاز بالرهان صندوقًا من زجاجات النبيذ الفاخر. لم تُحسَم المنافسة بين نظريتي المعلومات المتكاملة ومساحة العمل، لوجود درجةٍ من التعارُض بين الأدلة العلمية حول أجزاء الدماغ المسؤولة عن التجربة البصرية، والإحساس الذاتي برؤية وجهٍ أو جسمٍ ما، وإنْ لم يعُد دور القشرة الجبهية الأمامية في تجربة الوعي يحظى بنفس الأهمية التي كان يحظى بها في السابق. وهكذا، خسرتُ الرهان، وأهديتُ تشالمرز صندوق النبيذ.
وُضعَتْ هاتان النظريتان لتفسير الرابط بين العقل الواعي والنشاط العصبي لدى الإنسان والحيوانات قريبة الصلة به تطوُّريًّا، مثل القرود والفئران. تقوم النظريتان على افتراضاتٍ عن التجربة الذاتية متباينةٍ فيما بينها أشدَّ التبايُن، وتنتهيان إلى استنتاجاتٍ متعارضة حول إمكان أن يوجد الوعي في أشياء من صُنع البشر. ومن هنا، فإنَّ نجاحنا من عدمه – وحجم هذا النجاح – في أن نثبت بالتجربة صحة أو خطأ هاتين النظريتين في تصوير علاقة الشعور بالدماغ يُعد مسألةً لها ما بعدها في محاولة الإجابة عن سؤال العصر: هل يمكن للآلة أن تشعر؟
عصر روبوتات الدردشة
قبل أن أخوض في تفصيل هذه المسألة، دعني أضعها في سياقها أولًا، من خلال المقارنة بين الآلات الواعية وتلك التي تصدُر عنها سلوكياتٌ ذكية فقط، أو تنمُّ عن ذكاء. غاية ما يقصد إليه مهندسو الحواسيب هو إكساب الآلات ذلك النوع من الذكاء عالي المرونة الذي أهَّل الإنسان العاقل المعاصر (Homo sapiens) للخروج من إفريقيا، لينتهي به الأمرُ وقد استوطن الكوكب بأكمله. يُشار إلى هذا النوع من الذكاء بالذكاء الاصطناعي العام (AGI). وقد ذهب الكثيرون إلى أنَّ هذا النوع من الذكاء هدفٌ بعيد المنال. وخلال العام الماضي، تحقَّقت قفزات غيرُ مسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي، أصابت بالذهول العالَمَ كله، ومنه الخبراء المتخصصون. ظهرت تطبيقات برمجية حوارية تمتاز بطلاقة التعبير، تُعرَف بروبوتات الدردشة (chatbots)، ومع ظهورها، تحوَّل الذكاء الاصطناعي العام من موضوعٍ يهم الشغوفين بالخيال العلمي، وخبراء التكنولوجيا الرقمية في وادي السيليكون، إلى جدالٍ ينمُّ عن حالة عامة من القلق من خطرٍ وجودي ما، يُهدِّد طريقة حياتنا، والجنس البشري برُمَّته.
تقوم فكرة هذه الروبوتات الذكية على نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، وأشهرها سلسلة البرامج الآلية المعروفة باسم المحولات التوليدية المُدرَّبة مسبقًا (GPT)، التي طوَّرتها شركة «أوبن ايه آي» OpenAI في مدينة سان فرانسيسكو. وإذا نظرتَ إلى أحدث إصدارات الشركة من هذه البرامج، وهو المسمَّى «جي بي تي 4» GPT-4، وما يمتاز به من طلاقة وسلاسة وكفاءة، فلن يصعُب عليك الاعتقاد بأن للتطبيق عقلًا وشخصية. وحتى سقطاته الغريبة، التي يُطلق عليها «هلاوس»، تدعم تلك الفكرة.
وإذا نظرتَ إلى «جي بي تي 4»، وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تنافسه، مثل نموذجي «لامدا» LaMDA و«بارد» Bard، اللذَين طرحَتهما شركة «جوجل»، ونموذج «لاما» LLaMA الخاص بشركة «ميتا»، لوجدتَ أنها مُدرَّبة بالاستعانة بمكتباتٍ من الكتب الرقمية، وملياراتٍ من صفحات الإنترنت المتاحة للجمهور عبر برامج فهرسة المواقع الالكترونية، المعروفة باسم «زواحف الويب» Web crawlers. وعبقرية هذه النماذج اللغوية الكبيرة إنما تكمُن في أنَّها تُدرب نفسها دون إشرافٍ خارجي، وذلك بحجب كلمةٍ أو اثتنين، ثم محاولة تخمين العبارة الناقصة. وهي تفعل ذلك مرارًا وتكرارًا، بل ملياراتِ المرات، دون تدخُّلٍ من أحد. وفور انتهاء النموذج من التعلُّم، بهضم كل ما سَطَره البشر على الإنترنت، يزوده المستخدم بمُدخلٍ ما – جملةٍ أو أكثر – مما لم يصادف النموذج قبلًا. حينها، يخمِّن النموذج الكلمة التي يرجِّح أنها التالية، ثم التي تليها، وهكذا. والحقُّ أن هذا المبدأ البسيط أتى بنتائج مذهلة في عديد اللغات، مثل الإنجليزية، والألمانية، والصينية، والهندية، والكورية، ولغاتٍ كثيرة أخرى، بل وفي الكثير من لغات البرمجة.
ولعلَّ مما يجدر بالذكر في هذا الصدد أنَّ المقال المؤسِّس للذكاء الاصطناعي على جملته، والذي ألَّفه عالم المنطق البريطاني آلن تورنج عام 1950 بعنوان «آلات الحوسبة والذكاء»Computing Machinery and Intelligence، لم يتطرق إلى السؤال عن قدرة الآلة على التفكير، الذي يمكن اعتباره صيغةً أخرى للسؤال عن مدى تمتعها بالوعي. اقترح تورنج «لعبة محاكاة»، تقوم على اختبار قدرة شخصٍ على أن يميز بموضوعية بين نصٍ كتبه إنسان وآخر كتبته آلة، حين تُحجب عنه هوية كلٍ منهما. يُعرف هذا الاختبار حاليًا باسم «اختبار تورنج»، وروبوتات الدردشة تجتازه بامتياز (وإنْ أنكرَتْ ذلك بدهاء إن سألتها عنه سؤالًا مباشرًا). وصحيحٌ أنَّ طريقة تورنج هذه قد أثمرت تقدُّمًا مذهلًا ودؤوبًا على مدى عقود، أفضى إلى تطوير نماذج GPT، إلا أنها لم تمسّ صلب المشكلة.
وواقع الأمر أن الجدل الدائر يقوم على افتراضٍ ضمني بأنَّ الذكاء الاصطناعي إنما يكافئ الوعي الاصطناعي، وأنَّ امتلاك الذكاء وامتلاك الوعي سواءٌ بسواء. وإذا كان الذكاء والشعور متلازمَين لدى البشر وغيرهم من الكائنات المتطورة، فإنَّ هذا ليس صحيحًا بالضرورة في حالة الآلة. وذلك لأنَّ الذكاء هو في جوهره إعمالٌ للعقل وتعلُّم بقصد التصرُّف في مسألةٍ ما؛ أي تعلُّم المرء من أفعاله وأفعال غيره من الكائنات المستقلة الأخرى، كي يصل إلى توقعاتٍ أفضل عن المستقبل ويُعِد له، سواءٌ أكان المستقبل هنا يعني الثواني القليلة التالية (كأن تُدرك أنَّ هناك سيارةً متجهةً نحوك بسرعةٍ كبيرة)، أم الأعوام المقبلة (كأن تقرر أنَّك ينبغي أن تتعلم البرمجة). وبالتالي، فإنَّ الذكاء يتمحور بالأساس حول الفعل.
أمَّا الوعي فيتعلق بحالات الوجود: أن ترى مثلًا السماء الزرقاء، أو تسمع زقزقة العصافير، أو تشعر بالألم، أو تقع في الحب. وخروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة لا يلزم له إطلاقًا أن يكون قادرًا على الشعور. كل ما يحتاجه حينها هو أن يكون له هدفٌ لا يتفق مع رفاهة البشرية على المدى الطويل. وليس من المهم حينها أن يكون الذكاء الاصطناعي مُدركًا لما يحاول فعله، وهو ما نسميه لدى البشر «الوعي بالذات». ما يهم حينها فقط هو أن يسعى الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا الهدف دون تفكير. لذا، على الأقل من ناحية المبدأ، إن استطعنا تطوير نموذج ذكاء اصطناعي عام، فإنَّ هذا لن يحسِم ما إذا كان هذا النموذج قادرًا على الشعور. وبأخذ هذا الوضع في الاعتبار، لنعُد إلى سؤالنا الأساسي حول الكيفية التي يمكن بها للآلة أن تتمتع بالوعي، ولنبدأ بأولى النظريتين.
تفترض نظرية المعلومات المتكاملة، أولًا، خمس خصائص جلية لأي تجربة ذاتية يمكن تخيُّلها. ثم تتساءل النظرية عما يتطلبه الأمر من أي دارةٍ عصبية كي تُجسِّد هذه الخواص الخمس، عبر تنشيط بعض الخلايا العصبية وإخماد الأخرى، أو عما يتطلبه الأمر من رقاقات الحواسيب لتنشيط بعض الترانزستورات وتعطيل الأخرى. فالتفاعلات السببية في دارةٍ في حالةٍ معينة، أو فكرة أنَّ أي خليتين عصبيتين في حالة نشاط يمكن أن تُنشِّطا خليةً عصبية أخرى أو تُخمداها – في كلتا الحالتين، يمكن تمثيل تلك التفاعلات في صورة شبكة من علاقات سببية بها عدد كبير من المتغيرات. هذه الشبكة من العلاقات تكافئ جودة التجربة، أي كيف تبدو، مثل سبب مرور الزمن بالنسبة لنا، وشعورنا بامتداد المكان، أو أنَّ الألوان لها مظاهر معينة. بالإضافة إلى هذا فالتجارب تكون لها كمية مرتبطة بها، وهي معلوماتها المتكاملة. وتلك الدارات التي لا تكافئ القيمة القصوى لمعلوماتها المتكاملة قيمة الصفر هي فقط الدارات التي يمكن أن تتصرف كوحدةٍ واحدة، وتتمتع بالوعي. وكلما زادت قيمة المعلومات المتكاملة، زادت صعوبة اختزال الدارة أو تبسيطها، وقلت إمكانية اعتبارها مجرد مجموعة من الدارات الثانوية المستقلة المُتراكِبة. كما تُشدِّد نظرية المعلومات المتكاملة على الطبيعة الثرية لتجارب الإدراك البشري. انظر حولك، مثلًا، لترى مدى الثراء البصري في العالم المحيط بك، وتبايناته وعلاقاته التي لا حصر لها. أو تأمَّل لوحة للفنان بيتر بروغل الأكبر، الفنان الفلمنكي الذي عاش في القرن السادس عشر، وصوَّر بلوحاته موضوعاتٍ دينية ومشاهد من حياة الفلَّاحين.
وأي نظامٍ تتسمُ طبيعته بهذا القدر من الاتصال، مثل الدماغ البشري، ويشبهه فيما ينطوي عليه من قوى السببية، سيكون واعيًا مثله من حيث المبدأ. لكنَّ هذا النوع من الأنظمة لا يمكن محاكاته، وإنَّما ينبغي تكوينه وبناؤه على صورة الدماغ. والحواسيب الرقمية اليوم تعتمد على درجةٍ منخفضة للغاية من التواصل (حيث تتصل مخرجات كل ترانزستور بمدخلات بضعة ترانزستورات أخرى)، مقارنةً بالأجهزة العصبية المركزية (تتبادل الخلايا العصبية القشرية المدخلات والمخرجات مع آلافٍ من الخلايا العصبية الأخرى). لذا فإنَّ الآلات الحالية، ومن بينها القائمة على التقنيات السحابية، لن تعي أي شيءٍ، مع أنَّها ستستطيع في النهاية أن تحقق أي شيءٍ يمكن للبشر فعله. ومن هذا المنظور، فإنَّ النماذج على شاكلة «تشات جي بي تي» ChatGPT لن تشعر بأي شيء. ولاحظ أنَّ هذه الفكرة ليست لها علاقة بإجمالي عدد مكونات النظام، سواءٌ أكانت تلك المكونات خلايا عصبية أم ترانزستورات، ولكن بكيفية اتصالها ببعضها. هذا الاتصال بين المكونات هو ما يحدد مدى تعقيد الدارة إجمالًا، وعدد الأوضاع المختلفة التي يمكن تهيئتها عليها.
النظرية المنافسة هي نظرية مساحة العمل العصبية الشاملة (GNWT)، وهي تنطلق من الفكرة السيكولوجية القائلة بأنَّ الدماغ يشبه مسرحًا، يؤدي الممثلون فيه أدوارهم على منصةٍ صغيرة مُضاءة تجسد حالة الوعي، بينما جمهور المتفرجين جماعة من المعالجات، تجلس في الظلام بعيدًا عن المنصة. المنصة هنا هي مساحة العمل المركزية في الدماغ، وذاكرتُها العاملة سعتُها محدودة، لا تكفي إلا لتمثيل عنصرٍ واحدٍ فقط من المُدرَكات أو الأفكار أو الذكريات. وتتنافس على هذه المساحة المركزية وحدات المعالجة المختلفة، تلك الخاصة بالرؤية، والسمع، والتحكم في حركة العينين والأطراف، والتخطيط، والاستدلال، وفهم اللغات، والتنفيذ. والفائز في هذه المنافسة يحل محل المحتوى القديم الذي كان يشغلها، والذي ينتقل حينها إلى اللاوعي.
هذه السلسلة من الأفكار يمكن تتبُّع أصولها وصولًا إلى النموذج الذي كان يُعرف باسم «منظومة اللوحة السوداء» Blackboard architecture في بواكير مجال الذكاء الاصطناعي، والذي كان يُسمَى بهذا الاسم كي يستدعي إلى الذهن صورة أشخاصٍ مجتمعين حول سبورةٍ سوداء يتناقشون في مشكلةٍ ما. وقد اتضحت العلاقة بين المنصة المجازية ووحدات المعالجة لاحقًا في نظرية مساحة العمل وبين بنية القشرة المخية الحديثة، تلك الطبقات المطوية الخارجية للمخ. مساحة العمل في هذا التصور هي شبكة من الخلايا العصبية القشرية في مقدمة المخ، ترتبط بوصلاتٍ طويلة المدى مع خلايا عصبية مشابهة، موزعة في أنحاء القشرة الحديثة بمناطق القشرات الرابطة قبل الجبهية، والجدارية الصدغية، والحزامية. وحين يتجاوز النشاط في القشرات الحسية حدًا معينًا، يترتب على ذلك تنشيط شامل لتلك المناطق القشرية، تُرسَل فيه المعلومات إلى مساحة العمل بأكملها. وبَثُّ هذه المعلومات على ذلك النحو الشامل هو ما يجعل مساحة العمل تتسم بالوعي. أمَّا البيانات التي لا تُشارك بهذا الشكل، كموضع العينين مثلًا، أو القواعد النحوية التي تساعد في تأليف جملةٍ مُصاغة بعناية، يمكنها أن تؤثر في السلوك، لكن دون وعي.
بحسب نظرية مساحة العمل، التجربة محدودةٌ بعض الشيء، ومُجردة وتشبه الأفكار، كالأوصاف المقتضبة التي قد نجدها في المتاحف أسفل أعمالٍ مثل لوحات بروغل: "مشهدٌ داخلي لمجموعة من الفلاحين، يرتدون ملابس من عصر النهضة في زفاف، ويأكلون ويشربون".
وبحسب فهم نظرية المعلومات المتكاملة لمسألة الوعي، فإنَّ الرسَّام هنا يُمثِّل ببراعة تحليله لظواهر العالم الطبيعي على لوحةٍ قماشية ثنائية الأبعاد. أمَّا من منظور نظرية مساحة العمل، فهذا الثراء البادي في اللوحة وهم أو خيال، وكل ما يمكن قوله بموضوعية عن ذلك الثراء يُعبر عنه بوصفٍ عام مُقتضب.
وبهذا فإنَّ نظرية مساحة العمل تتبنى تمامًا سردية عصرنا، عصر الحواسيب، التي ترى أنَّ كل شيءٍ يمكن اختزاله في صورة عملية حوسبة. ولذلك، فلو وُجدت نماذج حاسوبية تحاكي الدماغ، مبُرمجة على النحو المناسب، ولديها ما يشبه مساحة العمل العصبية المركزية، وتتلقى مردودًا كبيرًا على استجاباتها، فإنَّها سيمكنها أن تختبر العالم بوعي. وهي ربما لن تفعل ذلك حاليًا، لكنَّها ستستطيع قريبًا.
تناقضات صارخة
يمكن القول إن هذا، بشكلٍ عام وواضح ومُبسَّط، هو الجدال المحتدم بين النظريتين. فوفقًا لنظرية مساحة العمل وغيرها من النظريات الوظيفية الحوسبية (تلك النظريات التي ترى الوعي على أنَّه بالأساس شكلٌ من أشكال الحوسبة)، الوعي ليس إلا مجرد مجموعة ذكية من الخوارزميات، تعمل على آلةٍ من آلات «تورنج». ووظائف الدماغ في هذا التصور هي فقط ما يتطلبه الأمر للتمتع بالوعي، وليس خصائص علاقات السببية في الدماغ. ولذا، إن تمكَّن نموذجٌ متطور، من نماذج «جي بي تي» GPT، من تلقي نفس أنماط المُدخلات التي يتلقاها البشر وإنتاج نفس المُخرجات، فإنَّه سيتمتع حينها بجميع خصائصنا، ومن بينها أثمن ما نحظى به: التجربة الذاتية.
وعلى النقيض، فبالنسبة لنظرية المعلومات المتكاملة، فإنَّ جوهر الوعي هو قوى السببية الكامنة، وليس عمليات الحوسبة. وقوى السببية هذه ليست شيئًا غير ملموسٍ أو فكرةٍ مُجرَّدة، وإنَّما هي حقيقيةٌ تمامًا، وتتحدَّد على المستوى الوظيفي بالمدى الذي يُسهم به ماضي أي نظامٍ في تشكيل حالته الحاضرة (قوة السبب)، وبالمدى الذي يُسهم به الحاضر في تشكيل المستقبل (قوة التأثير). والمعضلة هنا أنَّ قوى السببية هذه في ذاتها، أي القدرة على جعل النظام يُقدم على فعلٍ معين وليس أيًا من بدائله الكثيرة الأخرى، لا يمكن محاكاتها الآن، ولن يمكن تحقيق ذلك في المستقبل، وإنمَّا يجب أن نجعلها جزءًا أساسيًا من الأنظمة.
انظر، مثلًا، إلى أكواد البرمجة الحاسوبية التي تحاكي معادلات الحقل في نظرية النسبية العامة لأينشتاين، والتي توضح العلاقة بين الكتلة وانحناء الزمكان. مثل هذا البرنامج يمكنه بدقة أن يضع نموذجًا للثقب الأسود فائق الكتلة الموجود في مركز مجرتنا. هذا الثقب الأسود يؤثر بقوى جذب هائلة للغاية على محيطه، إلى درجةٍ تُعجز جميع الأشياء عن الإفلات من قوة سحبه، حتى الضوء، وهو ما يفسر تسميته بالثقب. ومع هذا، فعلماء فيزياء الفلك الذين يعملون على محاكاة الثقب الأسود لن تبتلعهم حواسيبهم المحمولة بقوة حقل الجاذبية في تلك المحاكاة. وهذه الملاحظة، وإنْ بدَتْ غير منطقية، تؤكد الفرق بين الحقيقي والمُحاكَى: فلو كانت المحاكاة مطابقةً للواقع، لا بد أن يحدث اضطرابٌ في حالة الزمكان حول الحاسوب، وأن ينشأ ثقبٌ أسود يبتلع كل ما حوله.
ليست الجاذبية عملية حوسبية بطبيعة الحال، وإنَّما هي ظاهرة بها قوى سببية، تُشوه نسيج الزمكان، جاذبةً كل ما له كتلة. ومحاكاة قوى السببية هذه لأي ثقبٍ أسود تتطلب جسمًا ماديًا فائق الكتلة، وليس فقط كودًا برمجيًا. أعني بذلك أنَّ قوى السببية لا يمكن محاكاتها، وإنَّما ينبغي إنشاؤها. وبهذا فإنَّ الفارق بين الحقيقي والمُحاكَى هو قوى السببية في كلٍ منهما.
ومن أجل ذلك، لا تمطر السماء بداخل حاسوبٍ يحاكي العواصف الممطرة. صحيحٌ أنَّ البرنامج هنا يكافئ المناخ من الناحية الوظيفية، لكنَّه يفتقر إلى قوى السببية خاصته، التي تحرك البخار وتحوله إلى قطرات ماء. ولذا فإنَّ قوى السببية، أي قدرة النظام على أن يغير في نفسه أو يتأثر بتغييرٍ ما، لابد أن تصبح جزءًا من النظام ذاته. وهذا ليس مستحيلًا، فالحواسيب المحاكية للبنى العصبية البيولوجية يمكنها أن تتمتع بالوعي مثل الإنسان، بخلاف الحواسيب القائمة على بنية فون نيومان التقليدية، والتي تُعد أساس جميع الحواسيب الحديثة. وقد طُوِّرَت نماذج أولية صغيرة من تلك الحواسيب المحاكية في المختبرات، مثل رقاقة «لويهي 2» Loihi 2 التي طوَّرتها شركة «إنتل» Intel، والتي تنتمي للجيل الثاني من الرقاقات المُحاكية للبنى العصبية البيولوجية. إلا أنَّ تطوير آلةٍ من التعقيد بحيث تُصدِر استجابات واعية كاستجابات البشر، أو حتى استجابات ذبابة الفاكهة، ما زال أمنيةً طموحة، لن تتحقق إلا في المستقبل البعيد.
ولنتذكَّر أنَّ هذه الفروق الهائلة بين النظريات الوظيفية والسببية لا علاقة لها بالذكاء، طبيعيًا كان أم اصطناعيًا. فكما أشرت سابقًا، الذكاء يتعلق بالسلوك. وأي شيءٍ يمكن للبشر إنتاجه ببراعتهم، حتى الروايات البديعة، مثل رواية «حِكَم المُزارع» Parable of the Sower لأوكتافيا إي. باتلر، أو «الحرب والسلام» War and Peace لليو تولستوي، يمكن للذكاء الخوارزمي أن يحاكيه، شريطة وجود مواد كافية ليتدرب عليها. ولذلك فإنَّ الذكاء الاصطناعي العام يمكن تحقيقه في مرحلةٍ غير بعيدة من مستقبلنا.
وإذن، فإن الجدل هنا يتمحور حول الوعي الاصطناعي، لا الذكاء الاصطناعي. ولن يكون في الإمكان حسم هذا الجدل بتطوير نماذج لغوية أضخم، أو خوارزميات شبكات عصبية أفضل. فإجابة هذا السؤال ستتطلب فهم التجربة الذاتية الوحيدة التي نتيقن منها: تجربتنا الذاتية. وبمجرد أن يصبح لدينا فهمٌ عميق للوعي البشري وأسسه العصبية، سيكون بمقدورنا تطبيق هذا الفهم على الآلات الذكية بطريقةٍ منطقية ومُرضِيَة من الناحية العلمية.
على أن هذا الجدل لا يؤثر كثيرًا في انطباع المجتمع عمومًا عن روبوتات الدردشة. فلن يطول الزمن قبل أن تطالعنا هذه الروبوتات، بقدراتها اللغوية، ومعارفها الواسعة، ولباقتها الاجتماعية، وهي خالية من العيوب تقريبًا، لا تشوبها شائبة؛ لأنَّها ستتمتع بذاكرةٍ مثالية، وبكفاءة ورصانة بالغتين، فضلًا عن قدرات الاستدلال والذكاء. حتى إنَّ البعض يرى أنَّ المرحلة القادمة في رحلة التطور ستكون مخلوقات من صنيع شركات التكنولوجيا الكبرى؛ هي أقرب شيء إلى الإنسان الأعلى (Superman)، إذا استعرنا مصطلح فريدريك نيتشه. أمَّا أنا، فتوقعاتي ليست بهذا التفاؤل، وأعتقد أنَّ ما يحسَبه هؤلاء الناس شروقًا لشمس جنسنا البشري، أراه في واقع الأمر غروبًا وأفولا.
وبالنسبة للكثيرين، وربما أغلب الناس في مجتمعنا الآخذ في التفتُّت، ذلك المجتمع المنفصل عن الطبيعة، والمنكفئ على شبكات التواصل الاجتماعي، هذه الكيانات الكامنة في هواتفهم ستأسرهم شعوريًا. وسيتصرف الناس بشتى الأشكال كما لو كانت روبوتات الدردشة هذه واعية، كما لو أنَّها يمكنها أن تحب حقًا، وأن تتأذى، أو تشعر بالأمل والخوف، حتى لو لم تكن سوى مجرد مصفوفات بيانات متطورة. وسوف يتعذَّر علينا العيش بدون هذه البرامج هذه البرامج أو الاستغناء عنها، بل ربما تتفوق في ذلك على الكائنات الواعية حقًا، مع أنَّها من الناحية الشعورية مثل تلفازك الرقمي، أو جهاز فرز الخبز: لا تشعر بشيءٍ على الإطلاق.
doi:10.1038/nmiddleeast.2023.231
تواصل معنا: